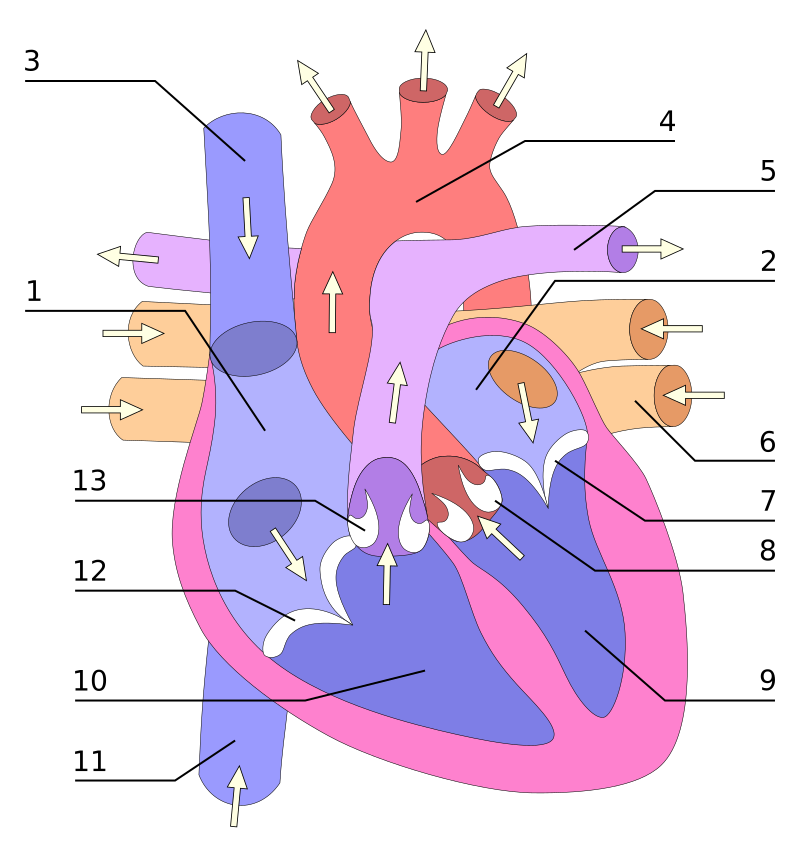
 مفسدات
القلب
مفسدات
القلب
القلب سيِّد الأعضاء ومَلِكُها، صلاحه صلاح لها، وفساده فساد لها؛ قال رسول الله ﷺ: «ألَا وإن في الجسد مُضْغَةً، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألَا وهي القلب».
أيها المسلمون: القلب سيِّد الأعضاء ومَلِكُها، صلاحه صلاح لها، وفساده فساد لها؛ يؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألَا وإن في الجسد مُضْغَةً، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألَا وهي القلب».
والقلوب مواطنُ نظرِ الله تعالى؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صُورِكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»؛ (رواه الإمام مسلم)، فالناس لا تتفاضل بحسن المظاهر، أو كثرة الأموال والأولاد، وإنما تتفاضل بما في القلوب من الطهارة، والخشية من الله تعالى، والتقوى، والصدق والإخلاص، وغيرها من أعمال القلوب، وما يصدُر عنها من الأعمال الصالحة بالجوارح.
فقلبُ المؤمن يسير به إلى الله عز وجل والدار الآخرة، يحمله على الخير ويحثُّه عليه، ويجنِّبه السوء ويحذره منه، ليتم له الوصول إلى مُبتغاه وغاية مَطلبِه؛ وهو رضا ربه عز وجل وجنَّته، إلا أن هناك قُطَّاعَ طريق بينه وبين مطلوبه، ومعوِّقين له عن الوصول لمبتغاه، وهم خمسة قواطع ومُفسدات له؛ تُطفئ نورَ القلب، وتُعمي عين بصيرته، وتُثقل سمعه، وتُضعف قِواه كلها، وتفتر عزيمته، وتُنكسه إلى وراء، وتُحدِث له أمراضًا وعِللًا، إن لم يتداركها العبد، خِيف عليه منها، ومَن لا شعور له بهذا، ولا خوف، فميتُ القلب.
وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله خمسًا من مُفسدات القلب، وبيَّن أثرها فيه، وحذَّر منها لتسلَمَ القلوب من العَطَبِ، وتكمل مسيرها إلى الله تعالى ورضوانه وجنته؛ لتصل بسلامٍ بإذن بارئها وفضله؛ والمفسدات هي:
أولًا: التعلُّق بغير الله تبارك وتعالى في طلب خيرٍ أو دفع ضرٍّ، وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق، فليس عليه أضرُّ من هذا الأمر، ولا أقْطَعُ له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلَّق القلب بغير الله تعالى، وَكَلَه الله إلى ما تعلَّق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره،والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله تعالى حَصَلَ، ولا إلى ما أمَّله ممن تعلق به ممن دونه سبحانه وَصَلَ؛ كما قال الله سبحانه: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا} [مريم: 81، 82]، فأعظم الناس خِذلانًا مَن تعلَّق بغير الله عز وجل، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظمُ مما حصل له ممن تعلق به، وهو مُعرَّض للزوال والفَوات، ومَثَلُ المتعلِّق بغير الله تعالى كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت، فهو أوهن البيوت، فأساس الشرك وقاعدته التي بُنِيَ عليها: التعلُّق بغير الله تعالى ولصاحبه الذَّمُّ والخِذلان؛ كما قال تعالى: {لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا} [الإسراء: 22]، مذمومًا لا حامد له، مخذولًا لا ناصر له، فمن تعلق قلبه بأحدٍ من الخَلْقِ في جلب نفع أو دفع ضرٍّ، أو تخاذَلَ عن الحق والتزامه ونصرته مجاملةً لأحدٍ من الخَلْقِ، ناله من الذم والخِذلان بقدر تعلُّقه بهذا المخلوق الضعيف، وخوفه، ومجاملته.
ثانيًا: كثرة الخِلطة، وذلك بكثرة مجالسة الناس، وغِشْيَانِهم في اجتماعاتهم، وكثرة الخِلَّان والأصحاب والجُلساء، وكثرة لُقياهم والْمُكث معهم، وإطلاق اللسان بالحديث، خاصةً في حديث لا ينفع في الآخرة، ويزداد الأمر سوءًا إن كانوا جلساء وأصحابَ سوءٍ، وكان الحديث بالباطل، فهذا النوع من الخلطة يملأ القلب من دُخَانِ أنفاسهم بالحديث السيئ حتى يسوَّد، ويُوجِب له تشتُّتًا وتفرُّقًا، وهمًّا وغمًّا وضعفًا، وإضاعة مصالحه،فكم جلبت كثرة خِلطة الناس فيما لا ينفع في الدين والدنيا من نقمة، ودفعت من نعمة، وأحلَّت رزِيَّة، وأوقعت في بَلِيَّة، وهل آفة الناسِ إلا الناسُ؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة تُوجِب له سعادة الأبد.
ويكفي ذمًا لمجالس اللهو ولو كان مباحًا لم يُذكر الله تعالى فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترةً يوم القيامة) رواه الترمذي وأبو داود، والترة: هي الحسرةً والندامة.
وهذه الخِلطة التي تكون على نوعِ مودةٍ ومصلحة في الدنيا من غير نفع في الآخرة، تنقلب عداوةً يوم الدين؛ كما قال تعالى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي} [الفرقان: 27 - 29]، وقال تعالى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف: 67].
وهذا شأن كلِّ أصحاب سوءٍ، يتوادُّون ما داموا متساعدين على حصول مرادهم من الدنيا، فإذا انقطع ذلك الغرض، أعقب ندامةً وحزنًا وألمًا، وانقلبت تلك المودة بغضًا ولعنةً وذمًّا من بعضهم لبعض.
والضابط النافع في أمر الخِلطة: أن يخالط الناس في الخير، ويعتزلهم في الشر، وفضول المباحات، فإذا دَعَتِ الحاجة إلى خِلطتهم في الشر، ولم يمكن اعتزالُهم، فالحذرَ الحذرَ من موافقتهم، وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، فليجتهد أن يقلِبَ ذلك المجلس طاعةً لله تعالى إنأمكنه، ويشجع نفسه، ويقوِّي قلبه، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطانيِّ القاطع له عن ذلك، بدعوى أن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك، ونحو ذلك، فليحاربه، ولْيَستغْنِ بالله سبحانه، ويؤثِّر فيهم من الخير ما أمكنه، وما أصعب هذا وأشقَّه على النفوس! وإنه لَيسيرٌ على من يسَّره الله تعالى عليه، فبين العبد وبينه أن يصدُقَ الله تباركوتعالى، ويلتجئ إليه، ويُكثِر من دعائه بأن يجعله مفتاحًا للخير، مِغلاقًا للشر؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الخير خزائنُ، ولتلك الخزائن مفاتيحُ، فطوبى لعبدٍ جَعَلَهُ الله عز وجل مِفتاحًا للخير، مِغلاقًا للشر، وويل لعبدٍ جَعَلَهُ الله مِفتاحًا للشر، مِغلاقًا للخير»؛ (رواه ابن ماجه، والطبراني)، فإذا علِم الله تعالى ما انطوى القلب عليه من الخير، وفَّق صاحبه ويسَّر له، وإلا صرفه وأضلَّه.
ثالثًا: ركوب بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم؛ كما قيل: إن الْمُنى رأس أموال المفاليس، الذين ليس لهم همَّة تُنال بها الفضائل والْمَكْرُمات، بل استبدلوا بذلك الأمانيَّ الذهنية، وكلٌّ بحسب حاله؛ فمنهم من يتمنَّى مِنَ الدنيا التَّطوافَ في البلدان، أو نَيلَ الشهوات من المناصب والجاه، والأموال والنساء، والخدم والأنعام والحرث، والذهب والفضة، وغير ذلك من مُتَعِ الدنيا، فيمثِّل المتمنِّي صورة مطلوبه في نفسه وخياله بأنه قد فاز بوصوله إليه، والتذَّ بالظَّفَر به، فبينا هو على هذه الحال، إذ استيقظ فإذا يده والحصير.
وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان، والعمل الذي يقرِّبه إلى الله تعالى، ويُدنيه منجواره، ساعِ لتحقيقها، سائلًا مولاه عز وجل أن يحققها لها فأمانيُّ هذا إيمانٌ ونورٌ وحكمة، وأمانيُّ أولئك خداع وغرور.
وقد مَدَحَ النبي صلى الله عليه وسلم باغيَ الخير المتمني له بصدقٍ، بل ذَكَرَ أن أجره في بعض الأمور كأجر فاعله؛ فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ هذه الأمة كمثل أربعة نفرٍ: رجل آتاه الله مالًا وعلمًا، فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علمًا ولم يُؤتِهِ مالًا، فهو يقول: لو كان لي مِثْلُ هذا، عمِلتُ فيه مثل الذي يعمل»، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهما في الأجر سواءٌ، ورجل آتاه الله مالًا ولم يُؤتِهِ علمًا، فهو يخبِط في ماله يُنفقه في غير حقِّه، ورجل لم يُؤتِهِ الله علمًا ولا مالًا، فهو يقول: لو كان لي مثل هذا، عمِلت فيه مثل الذي يعمل»، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهما في الوِزْرِ سواء»؛ (رواه الإمام أحمد، وابن ماجه بسند صحيح)، وقد تمنَّى النبي صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الوداع أنه لو كان تمتَّع وحلَّ إحرامه ولم يسُقِ الهَدْيَ، وكان قد حجَّ قارنًا، فأعطاه الله ثواب القِران بفعله، وثواب التمتع الذي تمنَّاه بأمنيته، فجمع له بين الأجرين.
فمن فرَّغ قلبه من الأماني الوضيعة، ومَلَأه مُنًى يحبها الله تعالى ويرضاها، وسعى لتحقيقها، فذاك الرابح الموفَّق، فقد فاز بأجرها ولو لم تتحقق له، ومن شغل قلبه بأمانيَّ دنيئة، فقد سعى لإفساده وعَطَبِهِ، وربما ناله من الإثم الذي يُوبِق دنياه وأُخراه.
الأول: ما يُفسده لعينه وذاته؛ كالمحرَّمات؛ وهي نوعان:
• محرمات لحقِّ الله تعالى: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، وذي الناب من السِّباع، والْمِخْلَبِ من الطير.
• ومحرمات لحقِّ العباد: كالمسروق، والمغصوب، والمنهوب، وما أُخِذَ بغير رضا صاحبه؛ إما قهرًا، وإما حياءً وتذمُّمًا.
الثاني: ما يُفسده بقدره وتعدِّي حدِّه؛ وذلك بالإسراف في المأكل والمشرب، والشبع المفرط؛ فإنه يُثقِله عن الطاعات، ويوسِّع مجاري الشيطان في البدن، فإنه يجرى من ابن آدم مجرى الدم؛ كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فالصوم يُضيِّق مجاريه ويسُدُّ عليه طرقها، والشبع يطرقها ويوسِّعها، ومن أكل كثيرًا، شرب كثيرًا، فنام كثيرًا، فخسِر كثيرًا؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ آدميٌّ وعاء شرًّا من بطن، بحسب ابن آدم لُقيمات يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإن كان لا محالة، فثُلُثٌ لطعامه، وثُلُثٌ لشرابه، وثُلُثٌ لنَفَسِهِ»؛ (رواه الترمذي والإمام أحمد)، يُحكى أن إبليس عرض ليحيى بن زكريا عليهما السلام، فقال له يحيى: هل نِلْتَ مني شيئًا قط؟ قال: لا، إلا أنه قُدَّم إليك الطعام ليلةً، فشهَّيتُه إليك حتى شبِعت منه، فنِمتَ عن وِردِك، فقال يحيى: لله عليَّ ألَّا أشبع من طعام أبدًا، فقال إبليس: وأنا لله عليَّ ألَّا أنصح آدمي أبدًا، فالاعتدال في المأكل والمشرب، وعدم التجاوز والمبالغة مَطلبٌ للحفاظ على القلب من الفساد، والصد عن كثيرٍ من الخير بسبب الشبع المذموم.
المفسد الخامس: كثرة النوم؛ فإنه يُميت القلب، ويُثقل البدن، ويُضيِّع الوقت، ويُورِث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدًّا، ومنه الضار غير النافع للبدن، وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أفضل وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، وكلما قرب النوم من الطرفين، قلَّ نفعه وكثُر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار، إلا لِسَهْرَان، ومن أوقات النوم المكروهة: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ فإنه وقت غنيمة، وللموفَّقين فيه مَزِيَّة عظيمة، فإنهم ولو طال قيامهم بالليل، لم يبادروا للنوم هذا الوقت حتى تطلع الشمس؛ فإنه أول النهار ومفتاحه، ووقت نزول الأرزاق، وحصول القسم، وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار، وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر.
وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وهو مقدار ثماني ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه، أثَّر عندهم في الطبيعة انحرافًا بحسبه.
ومن النوم الذي لا ينفع أيضًا: النوم أول الليل بعد غروب الشمس مباشرة، حتى تذهب فحمة العشاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه، فهو مكروه شرعًا وطبعًا.
وكما أن كثرة النوم مُورِثة لهذه الآفات، فمدافعته وهَجْرُه بكثرة السهر مُورِث لآفات أخرى عِظام؛ من سوء المزاج، وانحراف النفس، ويُورِث أمراضًا مُتْلِفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها، وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به، فقد أخذ بحظِّه من مجامع الخير، وإذا أذهب النوم حقًّا لله تعالى وصرف عنه؛ كالصلاة المكتوبة، وقيام الليل ولو بركعات يسيرة، أو أذهب حقَّ النفس والعيال من طلب الرزق والسعي فيه - كان مذمومًا ممقوتًا صاحبه، فالعاقل الحصيف من يقدره قدره، ويأخذ بزمامه ليستفيد منه، ويسخِّره لمصلحته، دون أن يستسلم له بلا هُدًى، فيضل السبيل، ويفوته الخير العظيم.
عباد الله: ولأن وقفنا مع هذه المفسدات الخمس للقلب، فإن ذلك لا يعني عدم وجود مفسد للقلب غيرها، وإنما هي الأبرز والأكثر أثرًا فيه بالسوء، ومن تأمل عددًا من المفسدات الكبار للقلب كالحسد والكبر والعُجب بالنفس أو القول أو العمل، وكذا والرياء وغيرهم من المفسدات، إنما هم ناشئون عن أحد المفسدات الخمس التي ذكرنا، فالرياء مثلًا ناشئ عن التعلق بغير الله تعالى، والحسد والكبر والعُجب بالنفس ناشئون عن كثرة الخلطة وركوب بحر التمني، والعاقل الموفق من يُجنب نفسه هذه المفسدات ليسلم له قلبه ويصفو، وعلى العبد أن يُكثر دعاء الله تعالى وسؤاله سلامة القلب وصلاحه، ويلتجئ إليه سبحانه ليحقق له هذا الفضل الكبير، فلا هادٍ لذلك إلا الله تعالى، مع بذل الجهد والمجاهدة للنفس والصبر والمصابرة على الحق وبذل الأسباب المشروعة للوصول للهدف السامي فإن الله عز وجل قال: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبلنا}، والقلب السليم السالم من المفسدات سبيل النجاة لصاحبه من غضب الله تعالى وناره يوم الدين، ونيل رضاه سبحانه وجنته، كما قال عز وجل في كتابه حاكيًا دعاء خليله إبراهيم عليه السلام: {وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}[الشعراء: 87 - 89].
اللهم اهدِ قلوبنا، وجنِّبنا ما يفسدها، واسلُل سخيمةَ صدورنا، واجعلنا هداةً مهتدين، غير ضالين ولا مُضلِّين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق